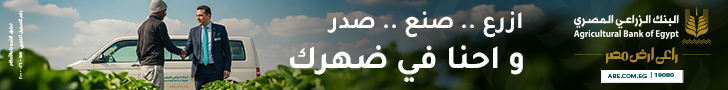رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن مشكلة القمامة وكيفية التخلص منها
بقلم / المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
مشكلة القمامة وكيفية التخلُّص منها – وهي ما اصطلح على تسميتها بالمخلَّفات الصلبة والسائلة – كانت تؤرِّق كثيرًا مِن الدول المتقدِّمة والنامية، لكنَّ الدول المتقدِّمة نظرَت إليها على أنها مشكلة يُمكن القضاء عليها بإنشاء المصانع لتدويرها والاستفادة منها في مناحٍ عديدة؛ أخصها توليد الطاقة منها، أما بعض الدول النامية، فلا زالت هذه المشكلة تَعترضها، ولم تضعْ لها حلولاً جذريةً، وبعضها اكتفى بحَرقِها أو دفنِها دون الاستفادة بخبرات مَن سبَقها، ونعرض في هذا المقال لحجم المشكلة وأضرارها، وكيفية التخلُّص منها في القانون المصري وقوانين الدول العربية والأجنبية، ثم لهَدْي الإسلام في وقاية البيئة منها.
تعريف القمامة:
عرَّفت المادة الأولى مِن اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة المصري رقم 38 لسنة 1967 والمعدَّل بالقانون رقم 31 لسنة 1976 – المقصودَ بالقاذورات والقمامة والمتخلفات بأنها: كافة الفضلات الصلبة أو السائلة المتخلِّفة عن الأفراد والمباني السكنية؛ كالدُّور الحكومية، ودور المؤسَّسات والهيئات والشركات والمصانع والمحال على اختلاف أنواعها، والمخيَّمات والمُعسكَرات والحظائر والسلخانات والأسواق والأماكن العامة والملاهي وغيرها، وكذا وسائل النقل، وكل ما يترتَّب على وضعها في غير الأماكن المخصَّصة لها أضرار أو نشوب حرائق، أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها.
وتتنوَّع هذه الفضلات؛ فهي تحتوي على بعض الأوراق والصناديق وقطع القُماش القديمة والزجاجات الفارغة والعلب المعدنية وعبوات الإيروسول، بالإضافة إلى بعض بقايا عمليات البناء والتشييد وقِطَع الأخشاب، وبعض المخلفات المعدنية، وبقايا الطعام، ونفايات المنازل، والمخلَّفات الصناعية والزراعية وقِطَع الأثاث المستهلكة وهياكل السيارات القديمة… إلخ.
حجم مشكلة القمامة وأضرارها:
تتميَّز المجتمعات الحديثة بأنماط زائدة من الاستهلاك، ولا يتوقف ذلك على الدول الغنية فقط، بل انتقلت هذه العدوى إلى كثير من الدول النامية، فزاد استهلاكها على إنتاجها، واختلَّ بذلك ميزانها الاقتصادي.
وقد صاحَبَ هذه الزيادةَ الهائلة في الاستهلاك زيادةٌ مُطردة في حجم القمامة التي ينبغي التخلص منها يوميًّا، خصوصًا في المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان، وأصبحَت هذه الكميات الكبيرة من القمامة مُشكلةً تُعاني منها كل الدول يومًا بعد يوم.
ففي دولة مثل الولايات المتحدة – وهي مِن أكبر الدول الاستهلاكية في العالم – تبلغ كمية المخلفات الناتجة من المصانع والمتاجر ومواد البناء وقمامة المنازل حدًّا هائلاً يَصل إلى نحو مليون طن يوميًّا؛ أي: بمعدل أربعة كيلو جرامات لكلِّ فرد في اليوم يتعيَّن التخلُّص منها حرصًا على الصحة العامَّة، وبلغتْ كمية النفايات الصلبة التي تُرفع يوميًّا من مدينة القاهرة أكثر من 5000 طن.
ولو تُركت هذه المخلَّفات مُعرَّضةً للهواء، لنمَتْ عليها جيوش من البكتريا والحشرات، وتعفَّنت المواد العُضوية الموجودة فيها، مما يؤدِّي إلى انتِشار الروائح الكريهة، وتُصبح مرتعًا خصبًا تتكاثَر فيه بلايين الحشرات كالذباب والبَعوض والصراصير، وعاملَ جذبٍ للجرذان والزواحف والقطط والكلاب الضالة؛ مما يتسبب في انتشار الكثير من الأمراض، وعلى رأسها: التيفوئيد، والتهاب الكبد الوبائي، والإسهال، وأمراض العيون، وبعض الوبائيات الفتاكة؛ مثل: الكوليرا وغيرها.
وبعض المخلفات الصلبة لا يُمكن التخلُّص منها بسهوله؛ نظرًا لأنها تستطيع مُقاومة العوامل الطبيعية إلى حدٍّ كبير؛ مثل العلب المعدنية ونفايات البلاستيك وهياكل السيارات القديمة وغيرها، وتظلُّ هذه المخلَّفات مِن مُلوِّثات البيئة الثابتة التي لا تتغيَّر لمدة عدَّة سنوات.
ولم يهتمَّ الإنسان القديم كثيرًا بالتخلص من النفايات؛ لأنه كان دائم التنقل والترحال؛ ولهذا كان يُلقي بمخلفاته في كل مكان، وبدلاً من أن يتخلَّص من هذه النفايات كان يَقوم بمُبارحة المكان والانتقال إلى مكان آخر، تاركًا وراءه هذه المخلفات.
وبعد نشأة المدن واستقرار الإنسان فيها، أصبح لزامًا عليه ابتكار طرائق فعالة لجَمع هذه المخلَّفات والتخلُّص منها، ولم يعد ممكنًا ترك هذه القمامة وغيرها مِن المُخلَّفات تتجمَّع حوله وحول مسكنه.
وأصبحت الحاجة الآن ماسة إلى نظام جمع وتخلُّص سليم مِن النفايات بالمدن الكبرى مثل القاهرة؛ حيث ينتج عن عدم الانتظام في جمع النفايات أن نحو 1700 طنٍّ مِن النفايات البلدية تُحرَق يوميًّا، أو تُترك متحللة في الشوارع مُسببةً مشاكلَ صحيةً تزداد حدة باعتبار أنَّ حجم السكان يزداد دائمًا، فإن من الضروري الاهتمام الفوري بهذه المُشكلة على المستويات المختلفة من المسؤولية.
ومما يجدر الإشارة إليه هنا هو أنه مع التوسُّع العمراني تُصبِح مقالب القمامة التي كانت نائيةً عن الكتلة السكنية – قريبةً جدًّا؛ ولذلك تلجأ الجهات المختصة إلى ردْم تلك المقالب واستِصلاحها، ويُسارع البعض بإقامة مبانٍ عليها، وهذا أمر خطير للغاية؛ حيث إنه بعد فترة زمنية طالت أو قصرت سرعان ما تظهَر عيوبٌ في تلك المباني مِن تصدُّعات ونحوه، وقد ينهار المبنى على من فيه، والسبب هو أن هناك مركَّبات وغازات معينة تنتج عن تحليل مواد القمامة المتناثرة في باطن الأرض، وتريد تلك الغازات أن تخرج إلى الفراغ، وعند خروجها تؤدي إلى حدوث خللٍ في طبقات التُّربة يَنعكِس بدوره على المبنى المقام، فيؤدِّي إلى تصدُّعه وانهياره.
لذلك يَجب ألا يكون المكان الذي سيقام عليه البناء قد سبق استخدامه كمقلَب للقِمامة، كما يجب أن تكون هناك خرائط واضحة في البلديات ومَجالس المدن تُعطي معلومات كافية عن أية قطعة أرض سيتمُّ البناء عليها، بالإضافة إلى الدراسات الجيولوجية الوافية عن طبيعة هذه الأرض ومدى صلاحيتها، ويفضَّل استغلال المساحات المستصلحَة من مقالب القمامة القديمة في إقامة متنزَّهات عامة للجمهور عليها، بعد زراعتها بالنَّخيل وبعض الأشجار، مما يُساعِد في مقاوَمة تلوُّث الهواء.
مشكلة القمامة في القانون المصري وكيفية معالجته لها:
لم يَقتصر المقنِّن المصري على معالجة مشكلة القمامة في القانون رقم 38 لسنة 1967 المعدَّل بالقانون 129 لسنة 1982، أو لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 134 لسنة 1968 بشأن النظافة العامة؛ وإنما تناول علاج هذه المشكلة في قانون البيئة الجديد رقم 4 لسنة 1994 في المادة 37 منه في الباب الثاني، التي تَحظر إلقاء أو معالجة أو حرْق القمامة والمخلَّفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بعيدًا عن المناطق السكنية والزراعية والمجاري المائية، وأناط قانون البيئة الجديد باللائحة التنفيذية له تحديدَ المواصفات والضوابط والحدِّ الأدنى لبُعد الأماكن المخصَّصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.
وألزم قانون البيئة الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شؤون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقًا لأحكام هذه المادة.
ويلاحَظ على هذا النص:
أنه لم يُشر ولو من بعيد إلى إعادة استخدام مواد القمامة (بواسطة المصانع أو المشروعات المتخصِّصة) كطريقة نظيفة واقتصادية للتخلُّص منها؛ وذلك لأنه تحدَّث فقط عن تحديد أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة.
ويؤخذ على هذا النصِّ ما يلي:
1- أنَّ المعالجة في أماكن مكشوفة إنما تمثِّل طريقةً بدائيةً لها مثالبها، وتَفتقِر إلى السلامة والأمان، بخلاف المصانع أو المعامل التي يُمكن أن تقوم بإعادة استخدام بعض مواد القمامة في بعض الأغراض؛ كتحويل المواد العضوية إلى سماد بلدي، كما أن هناك بعض المتعهِّدين المتعاقدين مع الإدارة في مصر الذين يقومون بتصنيف مواد القمامة واستخراج ما يَصلُح منها لإعادة الاستعمال؛ كالزجاج، والمعادن، والبلاستيك.
2- أن المقنِّن في مصر لا يزال يَعتبر حرق القمامة وسيلة يعتمد عليها للتخلُّص منها، رغم ما لها من آثار سيئة على البيئة، وهذه الطريقة لم تعد تُستخدم حتى في كثير من الدول المتخلفة.
وكان المقنِّن المصري في قانون البيئة الجديد حريصًا أيضًا على نظافة البيئة المائية من التلوث بالقمامة، وذلك حينما فرض حظرًا على جميع السفن والمنصَّات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة المائية لمصر، وكذلك السفن التي تَستخدم الموانئ المصرية في إلقاء القمامة أو الفَضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية مصر العربية.
وأوجب المقنِّن المصري على السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات، أو في الأماكن التي تحدِّدها الجهات الإدارية المختصَّة مقابل رسوم معينة يصدُر بها قرار من الوزير المختص.
ولم يكتف المقنِّن المصري في قانون البيئة الجديد بذلك، بل أوجب تجهيز جميع موانئ الشحن والتفريغ والموانئ المعدَّة لاستقبال السفن وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة، وفضلات السفن من القمامة.
وأما عن كيفية رفع القمامة:
فقد أوجب قانون النظافة العامة المصري في مادته الثانية على شاغلي العقارات المبنيَّة بصفة عامَّة، سواء أكانوا من السكان العاديين أم من أصحاب ومديري المحلات العامة – حفظَ القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها في أوعية خاصَّة، وتسليمها إلى جامع القمامة التابع للمتعهِّد أو التابع للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة، أو وضعها في الأماكن المخصَّصة لذلك، والتي تحدِّدها هذه الجهة، ويُشترط في الأوعية المخصصة لحفظ القمامة أن تكون مصنوعةً من مادة صمَّاء لا تسمح بتسرب السوائل والفضلات، وتسري أحكام هذا القانون في المدن كما تسري في القرى التي يصدُر بتحديدها قرار من المحافظ المختص.
وقد جعلت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للجهة القائمة على أعمال النظافة – وهي المجلس المحلي المختص – أن تتولى بأجهزتها جمع القمامة والقاذورات والمتخلفات، ونقلها إلى الأماكن المخصَّصة لذلك، والتخلُّص منها، ولها أن تعهد بهذه العمليات أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقًا للشروط والمواصَفات والأوضاع التي يقرِّرها المجلس المحليُّ المختص، كما جعلت نفس المادة لهذه الجهة أيضًا تحديد أماكن وضع الفضلات تمهيدًا لنقلها.
وأن تُخصَّص صناديق وسلال بالطرقات والميادين، بحيث يحظر إلقاء المخلفات في غير الأماكن أو الصناديق أو السلال المخصصة لذلك.
ونُلاحظ أن نص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون النظافة العامة في مصر معيبٌ؛ لأن نقل القمامة إلى الأماكن المخصصة لها للتخلُّص منها، وكذلك تحديد أماكن تجميعها أو وضع الصناديق بالأماكن العامة – ليس مجرد حق للجهة القائمة على أعمال النظافة العامة، لها أن تقوم به أو أن تَمتنع؛ وإنما هو في الحقيقة واجب عليها، ويَكفي أن نتصوَّر ما يمكن أن يحدث إذا تقاعست هذه الجهة عن القيام بهذا العمل المهم أو أهملت فيه.
ونظرًا لما تتكلَّفه أعمال النظافة العامة من مال، فقد صدر القانون 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون رقم 38 لسنة 67، والذي نصَّ في مادته الثامنة على أن: يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية:
أ) من جنيه إلى 10 جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات والمدن التي صدَر بشأنها قرار جُمهوريٌّ باعتبارها ذات طبيعة خاصة.
ب) من جنيه إلى 4 جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية في المدن غير عواصم المحافظات.
ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية والأراضي الفضاء المستغلَّة والوحدات المستخدمة مقارَّ لأنشطة المِهَن والأعمال الحرة.
د) تُعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خِدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
وحظرت المادة الأولى من قانون النظافة العامة المصري 38 لسنة 1967 “وضع القمامة والقاذورات أو المتخلفات أو المياه القَذِرة في غير الأماكن التي يحدِّدها المجلس المحلي”.
مشكلة القمامة في قوانين البلاد العربية وكيفية معالجتها:
اهتمَّت قوانين الدول العربية بمُعالجة مشكلة القمامة بإصدار قوانين المحافظة على النظافة العامة، ونذكر منها: المرسوم الكويتي الصادر في سبتمبر 1977.
أما في دولة الإمارات العربية المتَّحدة، فيدخل موضوع رعاية النظافة العامة في الاختِصاصات المحلية لكل إمارة، وفي إمارة أبو ظبي – على سبيل المثال – يوجد نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمَحلات التجارية العامة رقم 11 لسنة 1972، المعدَّل بالقانون رقم 4 لسنة 1975، والقانون رقم 8 لسنة 1979.
وفي إمارة دبي:
نصَّت المادة م 2 من الأمر المحلي رقم 28 لسنة 85 بشأن النظافة العامة على أنه: “يُحظر أن يلقى أو يوضع أو يُترَك أو يسيل أو يُفرز في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور المنازل وغيرها من الأماكن، سواء كانت عامة أو خاصة – أيٌّ مِن المواد أو الأشياء الآتية: (القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها… إلخ)”.
وقد بدأت بعض دول الخليج – كالمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، والكويت – في إنشاء مصانع لمُعالَجة القمامة وإعادة استخدام عناصرها، ولا شكَّ أنَّ هذا هو أفضل الطرق للتعامل مع القمامة.
وفي سلطنة عمان:
أوجبت القوانين على الإدارة المختصة إجراء دراسات الجدوى؛ للوقوف على إمكانية إعادة استخدام مكونات المخلفات الصلبة غير الخطرة في الأغراض المختلفة، كما ألزمتها بإعداد بيان يوضح التأثير البيئي لكل موقع من مواقع طمر أو تصريف المخلفات وكُلفتها، فضلاً عن ذلك بإعداد خطة رئيسية شاملة طويلة المدى لجمع وتخزين ونقل ومعالجة والتخلُّص من هذه المخلفات.
ولم يَخرج المقنِّن اللبناني في المرسوم بقانون رقم 8735 لسنة 1974 الخاص بالمحافظة على النظافة العامة – عن قوانين باقي الدول العربية في موقفه من مشكلة القمامة وكيفية معالجتها ونقلها، وفرض العقوبات المالية، بل والمقيدة للحرية على مخالفي أحكامه، وإن اختلفَت صياغته ومقدار الغرامة المالية لديه.
ففي المادة 13 من ذات القانون نصَّ المقنِّن اللبناني على تَخصيص أماكن تُعينها البلديات لمُعالَجة النفايات والفَضلات الزراعية والصناعية، وفي المادة 14 أيضًا سَمح المقنِّن اللبناني بتجميع المركَّبات والسيارات المهملة وأنقاضها وهياكلها وأجزائها في مستودَعات مسوَّرة بجدران تَحجُبها عن النظر خارج المناطق السياحية والسكنية ومناطق الشواطئ.
وأما عن التخلُّص من القمامة، فقد ألزم المقنِّن اللبناني البلديات بتجهيز أوعية فنية خاصة محكمة الأقفال لتَجميعها قبل نقلها بوسائل نقل غير مَكشوفة، كما ألزَمَها وضع سلاسل فنية كافية على جوانب الطرق والأماكن الآهلة.
أما المقنِّن الليبي، فقد وضع القانون رقم 13 لسنة 1984 الذي تناول فيه الأحكام الخاصة بالنظافة العامَّة، ونظَّم بمُقتضاه طرق وأساليب ووسائل التخلص من النفايات والقمامة ومخلفات المباني وغيرها، ومنَع إلقاءها أو التخلُّص منها في غير الأماكن المخصَّصة لهذا الغرض، كما منع إلقاءها في الشوارع أو في الحدائق وغيرها من الأماكن المفتوحة للجمهور.
وفي المادة السادسة حدد القانون الليبي صور وطرق نظافة المباني العامة والشوارع والأماكن العامة، وألزم الجهات المختصة بذلك، كما نصَّ على أن تتولَّى الشركات والمصانع وغيرها من المنشآت التي تنتج عن أنشطتها مخلَّفات خطرة أو ضارَّة بالصحة العامة (مثل المخلفات الكيماوية).
وكانت ألمانيا قد أصدرت قانون المخلفات الصلبة سنة 1973 ليحدِّد طرق جمع ومعالجة المخلفات الصلبة والتخلُّص منها، وشجَّعت هذه القوانين المقاولين على استخدام المخلَّفات في أعمال صيانة مُختلفة؛ مثل إعادة صَهر الخردة، أو استخدام المخلَّفات كوقود في محطات توليد الكهرباء، أو استخدام بعض الأنواع في إنتاج مواد بناء، إلى غير ذلك من استخدامات ممكنة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية صدرت بعض القوانين التي تُرغم بائعي المرطِّبات على قبول الزجاجات الفارغة مُقابل رهن يُدفع للمُستهلك، كما تُرغم منتجي المُرطِّبات على قبول هذه الفوارغ من البائعين وإعادة استخدامها في عمليات التعبئة مرةً أخرى، وبهذا أمكن التخلُّص بدرجة كبيرة من كميات الزجاجات الفارغة التي كانت تُلقى بسبب عدم الاستخدام مرة أخرى.
هذه هي مشكلة القمامة، وأضرارها، وكيفية معالجتها في قوانين بعض الدول، فما هو موقف الإسلام منها؟
هدْي الإسلام في وقاية البيئة من التلوث بالقمامة:
الإسلام دين النظافة؛ جاءت أحكامه وقواعده تحثُّ عليها وتأمُر بها؛ فهي عنوان المجتمع الإسلامي وشعارُه الذي يتميَّز به عن سائر المجتمعات، وهو مجتمع طاهر البيئة، ظاهر الصحَّة، قويٌّ في بنيان أفراده، تفوح من أرضه رائحة الطُّهر والنقاء، على خلاف غيره مِن المُجتمعات الأخرى التي اتَّخذت القذارة دينًا وديدنًا لها لا تَبرحه ولا تنفكُّ عنه، بل تجعل منه شعارًا للزهد، وقربة وعبودية لمن تعبُدُه.
وما حَرَص الإسلام على نظافة مجتمعه إلا بسبب أنَّ رسالته هي الباقية الخالدة، والأسوة والقدوة التي تقود العالَم لخيرَي الدنيا والآخرة، لو تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ.
والقمامة خبائث ونجاسة تُنافي طهارة المجتمع المسلم؛ ولهذا نجد القرآن الكريم يقرِّر أنَّ الله عزَّ وجلَّ خلَق الأرض على أحسن حال، وأكمل خلقها، وأنَّ الإنسان بانحرافه عن منهج خالقِه يلوِّثها ماديًّا ومعنويًّا، يقول رب العزة: ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: 85].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((جعلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا))، والأرض لن تكون كذلك إلا إذا طهرت من القمامة والنجاسة، وإلا لا تصحُّ الصلاة عليها، فضلاً عن أنه يَجوز التيمُّم منها عند انعِدام الماء، فكيف يتيمَّم المسلم من الأرض النجسة؟!
والمتأمِّل لآيات القرآن العظيم يلحَظ هذه المنحة الربانية للإنسان، التي تتجلَّى في خلق بيئة جميلة نظيفة، فيها كل ما يُبهج القلب ويبعث السرور في نفس الناظر؛ قال تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ * وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق: 6 – 8].
والقرآن الكريم حينما يلفت النظر إلى ذلك فإنما يُريد من المؤمنين أن يعمَلوا جاهدين للحفاظ على بيئتهم من النجاسة، ويُواظبوا على تنظيفها وتطهيرها لحمايتها من أي ضرر يلحقها؛ لتظلَّ دائمًا كما خُلقت في صورة جميلة كجَمال خالقها؛ ((فإنَّ الله جميل يحبُّ الجمال)) كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا المَقال نَعرض لهدْي الإسلام في المحافظة على البيئة مِن التلوُّث بالقمامة في أربع نقاط على النحو التالي:
الأولى: هدْي الإسلام في الحث على نظافة الطرق العامة والمساجد:
1- نظافة الطرق العامة:
اهتمَّ الإسلام كعادته في المُحافظة على النظافة والصحة بنظافة الطرقات العامة من كل أذى يُلقيه فيها المارة، ووضَع النبي صلى الله عليه وسلَّم في حديثه حقوقًا للطريق العام، أوجَبَ على المسلمين رعايتها والالتزام بها؛ حتى يتحقَّق انتفاع الكافة بها، فالطريق ملكيَّة عامة للناس، يحافظون عليه ويستخدمونه الاستخدام الأمثل الذي لا يضرُّ الغير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلَّم المسلمين من الجلوس في الطرقات، قالوا: ما لنا بدٌّ من مجالسنا نتحدث فيها، فقال: ((فإن أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطرق حقها))، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: ((غضُّ البصر، وكفُّ الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر)).
وجعل النبي صلى الله عليه وسلَّم إماطة الأذى عن الطَّريق شعبةً مِن شُعب الإيمان، واعتبَرَ هذا العمل الخفيف الجليل صلاةً مرَّةً، وصدقةً مرة أخرى؛ ففي الحديث: ((حملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك الأذى عن الطريق صلاة)).
وفي حديث آخر: ((بكلِّ خطوة يَمشيها إلى الصلاة صدقة، ويُميط الأذى عن الطريق صدقة))؛ أي: إزالة الأذى من حجر أو شوك أو نجاسة أو قمامة تلوِّث الطريق، أو ما أشبه ذلك.
عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قلتُ: يا رسول الله، علِّمني شيئًا أنتفِع به، قال: ((اعزِلِ الأذى عن طريق المسلمين)).
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((على كل ميسم من الإنسان صلاة كل يوم))، فقال رجل مِن القوم: هذا من أشد ما أنبأتنا به، قال: ((أمرُك بالمعروف ونهيُك عن المنكر صلاة، وحملك عن الضعيف صلاة، وإنحاؤك القذر عن الطريق صلاة))، وفي رواية: ((وإماطتك الحجر والشوكة والعَظْم عن طريق الناس صدقة)).
إن عناية الإسلام بالنظافة والصحة جزء من عنايته بقوة المسلمين المادية والأدبية، فهو يتطلب أجسامًا تجري في عروقها دماء العافية، ويَمتلئ أصحابها فتوة ونشاطًا؛ فإن الأجسام المهزولة لا تطيق عبئًا، والأيدي المُرتعشة لا تقدِّم خيرًا.
وللجسم الصحيح أثر لا في سلامة التفكير فحسب، بل في تفاعل الإنسان مع الحياة والناس، ورسالة الإسلام أوسع في أهدافها وأصلب في كيانها من أن تَحيا في أمة مُرهقة موبوءة عاجزة؛ ومِن أجل ذلك حارَب الإسلام المرض، ووضَع العوائق أمام جراثيمه؛ حتى لا تَنتشر فينتشر معها الضعف والتراخي والتشاؤم، وجاءت أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلَّم تجعل المُحافظة على نظافة الطريق العام سببًا لدخول الجنة، وزيادة الحسنات.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلَّم: ((مرَّ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحينَّ هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأُدخل الجنة))، ويقول صلى الله عليه وسلَّم: ((لقد رأيتُ رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذِي الناس))؛ أي: يتنعم في الجنة بملاذِّها بسبب قطعه الشجرة، وكان شُريح إذا مات لأهله سِنَّور، أمر بها فألقيت في جوف داره؛ اتقاءً لأذى المسلمين.
وعن معاوية بن مرة قال: كنتُ مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمرَرْنا بأذى، فأماطه أو نحَّاه عن الطريق، فرأيت مثله فأخذته فنحَّيتُه، فأخذ بيدي وقال: يا بن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عمِّ، رأيتُك صنعتَ شيئًا فصنعتُ مثله، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَن أماط الأذى مِن طريق المسلمين، كُتبت له حسنة)).
وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((عُرضت عليَّ أعمال أمتي حسنُها وسيئُها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يُماط عن الطريق)).
ومِن وسائل الوقاية المُحكمة التي شرَعها الإسلام إيجابية قضاء الحاجة في أماكن معزولة؛ حتى تذهب الفضلات الحيوانية في مستقرٍّ سحيق، فلا يتلوث بها ماء، ولا يتنجَّس طريق ولا مجلس، ولو أنَّ الساكنين في وادي النيل أخذوا أنفسهم بهذا الأدب الجليل، لنَجَوْا مِن غوائل الأدواء التي هدَّتْ قواهم، وأنهكت قراهم، وجشَّمتهم العنت الكبير؛ فعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه “نهى أن يُبال في الماء الراكد”، وعنه أيضًا: “نهى أن يُبال في الماء الجاري”.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((اتقوا اللاعنَينِ))، قالوا: وما اللاعنان؟ قال: ((الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)).
وعن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل))؛ أي: إن هذه الأمور تجلب على فاعلها اللعنة.
والشخص الذي يتخلى في الطريق العام ساقط المروءة، فهو يأتي فعلاً يُثير الاشمئزاز ويَستوجِب السخط، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((مَن آذى المسلمين في طرُقِهم، وجبتْ عليه لعنتهم))، وفي رواية: ((مَن غسل سخيمته على طريق من طرق المسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)).
ومن آداب قضاء الحاجة: البُعد والاستتار عن الناس، لا سيما عند الغائط؛ لئلا يُسمع له (صوت)، أو تُشمَّ له رائحة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: خرجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلَّم في سفر، فكان لا يأتي البراز – مكان قضاء الحاجة – حتى يغيب فلا يُرى.
وهذه المنهيات كلها أساس انتشار الأمراض المتوطِّنة على ضفاف النيل؛ إذ إنَّ العوام استهانوا بها فجرَّت عليهم الوبال، والأحاديث المذكورة آنفًا واضحة وظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق، سواء أكان الأذى شجرةً تُؤذي، أم غصنَ شوكٍ، أم حجرًا يُعثر به، أم قذرًا، أم جيفةً، أم غير ذلك، وهي حجة في وقاية الطريق العام من التلوث بكافة أنواعه، سواء أكان هذا في الطريق أم في الأسواق أم في النوادي وغيرها في كل بيئة يعيش فيها ويَرتادها الناس، وفي الأحاديث تنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم الضرر.
2- نظافة المساجد:
فهي دُورُ العلم والعبادة، وأماكن اجتماع الناس ومواضع احتفالاتهم، فعندما يذهب الإنسان طاهرًا نظيفًا، ويجد المكان نظيفًا طاهرًا، ومَن جاوَرَه في المكان أيضًا نظيفًا طاهرًا متطيبًا، فإن هذا لا شكَّ أدعى إلى بعث السرور في النفس والانشراح في الصدور، وأبعث على طرد السأم والملل والضجر والفرار من المكان ومن فيه، وأيضًا فيه الوقاية من الأمراض والأوبئة، وفيه حفظ الصحة.
والمساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلَّم كانت مَفروشة بالحصباء، وليستْ كمَساجدنا اليوم، ولم تكن فيها دورات للمياه ولا أماكن للوضوء، وبالرغم من ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلَّم يُخاطب الأمة في شخص أصحابه ويُعلِّمهم ضرورة المحافظة على نظافتِها.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلَّم: ((البزاق في المسجد خطيئة، وكفَّارتها دفنُها))، وعنه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول: ((التفل في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنُها))، وعنه كذلك قال: بينَما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلَّم إذ جاء أعرابي يَبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: مه مهٍ! قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((لا تزرموه، دعوه))، فتركوه حتى بال، ثم إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم دعاه فقال له: ((إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء مِن هذا البَول ولا القذر؛ إنما هي لذِكر الله عزَّ وجلَّ، والصلاة، وقراءة القرآن))، أو كما قال صلى الله عليه وسلَّم، فأمَر رجلاً من القوم فجاء بدَلوٍ من ماء فشنَّه عليه.
وفي الحديث: صيانة للمساجد وتزيينها عن الأقذار والقذى والبصاق وخلافه، ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما مَن على بدنه نجاسة، فإن خاف تنجيس المسجد لم يَجُز له الدخول، فإن أمن ذلك جاز.
وأما إذا افتصد في المسجد (شق العرق، وافتصد فلان: إذا قطع عرقه) فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، ويستحبُّ استحبابًا متأكدًا كنْسُ المسجد وتنظيفه.
وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُود ﴾ [البقرة: 125]، والمعنى: طهِّراه من الأوثان والأنجاس، وطواف الجنب والحائض، والخبائث كلها.
وعن أبي ذرٍّ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((عُرضت عليَّ أعمالُ أمَّتي، حسنُها وسيئُها، فوجدت في مساوئ أعمالها: النُّخاعة تكون في المسجد لا تُدفَن)).
وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم رأى بصاقًا في جدار القِبلة أو مخاطًا أو نخامة، فحكَّه.
لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلَّم بهذا أن يؤصِّل في الناس عادات جديدة تتماشى مع القواعد الصحيحة، فاستعمل أسلوبًا مثيرًا مؤثِّرًا؛ ليزيح به عن البيئة بعض الأخطاء التي التصقت بها، وعدم المبالاة بالبصق أو التمخُّط في الطرق العامة، فاهتمَّ صلى الله عليه وسلَّم بنظافة ما تجمَّد منها بنفسه بالعراجين (وهي سباطة البلح بعد نزعه منها)؛ ليكون ذلك بيانًا عمليًّا للحرص على النظافة، وعلى كل إنسان أن يُسهم بصورة حيَّة ومَلموسة في نظافة البيئة التي يحيا في وسطها؛ فإن ذلك فضلاً عن كونه واجبًا صحيًّا، فهو واجبٌ شرعي أيضًا.
واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة، على صاحبها أن يكفر عنها بدفنها، ويرى جمهور العلماء دفنها في تراب المسجد ورملِه وحصاته إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاة، وإلا فليُخرِجها، والقبح والذمُّ لا يختص بصاحب النخامة، بل يدخل فيه هو وكل مَن رآها ولا يُزيلها بدفن أو حك ونحوِه.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا تنخَّم أحدكم في المسجد، فليُغيِّب نخامته؛ أن تُصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتُؤذيه.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((من تنخَّع في المسجد فلم يَدفِنه فسيِّئة، وإن دفنه فحسنة))، وقال ابن أبي جمرة: لم يقلْ يُغطِّيها؛ لأنَّ التغطية يستمرُّ الضرر بها؛ إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتُؤذيه، بخلاف الدَّفن فإنه يُفهَم منه التعميق في باطن الأرض.
وقال النووي في رياض الصالحين: “المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيًّا أو رمليًّا، فإذا كان مبلطًا مثلاً فدَلكها عليه بشيء، فليس ذلك بدفن، بل زيادة في التقذير”، قال الحافظ ابن حجر: “لكن إذا لم يبقَ لها أثر ألبتَّة، فلا مانع، وعليه يُحمَل حديث عبدالله بن الشخِّير: ثمَّ دلَكه بنعلِه، وفي رواية طارق: وبزق تحت رجله ودلَكَ”، وقال الحافظ: “الروايتان عند أبي داود إسنادهما صحيح”.
وعن أبي عبيدة بن الجراح “أنه تنخَّم في المسجد ليلةً فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ شُعلةً من نار ثم جاء فطلَبها حتَّى دفَنَها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب عليَّ خطيئةً الليلة”.
الثانية: هدي الإسلام في الحث على نظافة البيوت:
فالبيوت هي مكان الاستقرار والراحة، يأوي إليها الإنسان مستغيثًا من شدة الحرِّ وزمهرير البرد؛ ولذلك حثَّ النبي صلى الله عليه وسلَّم على طهارتها ونظافتها؛ حتى يتميَّز المسلمون عن غيرهم من اليهود الذين يَجمعون الأكباء (الزبالة والقاذورات) في دُورهم؛ يقول عليه الصلاة والسلام: ((إن الله طيب يحب الطِّيب، نظيف يحب النظافة، كريم يُحبُّ الكرم، جواد يحب الجود، فنظِّفوا أفنيتكم وساحاتكم، ولا تشبَّهوا باليهود يجمعون الأكباء في دورهم)).
وقد نبه الإسلام إلى تخلية البيوت من الفضلات والقمامة؛ حتَّى لا تكون مباءةً للحشَرات ومصدرًا للعِلَل، وكان اليهود يُفرِّطون في هذا الواجب، فحُذِّرَ المسلمون من التشبُّه بهم؛ فعن عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((طهِّروا أفنيتَكم؛ فإن اليهود لا تطهِّر أفنيتَها))، وفي رواية: ((نَظِّفُوا أفنيَتَكُم؛ فإنَّ اليهود أَنتَنُ النَّاس))؛ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، كتاب الأدب، باب النظافة، وحسَّنه الألباني في المشكاة.
وفي هذه الوصية دليل على أنَّ الجَمال الإسلامي كان أصيلاً، ولم يكن بتأثيرٍ من البيئة الحارَّة، كما اعتقد بعض الباحثين الغربيِّين، أو مِن تأثير مناهج أو شرائع سابقة.
ولشدة حِرْص الإسلام على نظافة البيوت والاعتناء بها، فقد حثَّ على صلاة النوافل فيها؛ فعن جابر أنه قال: “إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجدِه، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإنَّ الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيرًا”، وبهذا كانت البيوت مساجد أخرى صُغرى، وكان لا بُدَّ من طهارتها كي تصلح للصلاة، وبهذا أمر النبي أُمَّته؛ فعن سمرة بن جندب قال: “أمَرَنا رسول الله أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمَرَنا أن نُنظِّفها”؛ أبو داود كتاب الصلاة، وأحمد، واللفظ له.
إنَّ الأماكن الطيبة النظيفة هي التي تنزل فيها الملائكة التي تحبُّ المكان النظيف الذي يفوح منه الرائحة الطيبة، وتنفر من الروائح الخبيثة، أما الشياطين، فإنها تنفر من الأماكن النظيفة ذات الرائحة الطيبة، وأحب شيء إليها الأماكن الكريهة المنتنة الرائحة.
تربية الكلاب في البيوت تلوِّثها وتهدِّد صحة ساكنيها:
ووجود الكلاب ببيت المسلم مظنَّة لنجاسة الأواني ونحوها مما يَلَغُ فيه الكلبُ، وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلَّم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليَغسِله سبع مرات إحداهنَّ بالتراب))، فاقتناء الكلاب للزينة حرام بالإجماع؛ فهي تمنع الملائكة من دخول البيوت، فتَسكنُها الشياطين، وعن النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: ((أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتُكَ البارحة فلم يَمنعني أن أكون دخلتُ إلا أنه كان على الباب ثماثيل، وكان في البيت قرام (ستر) فيه تماثيل، وكان في البيت كلبٌ، فمُرْ برأس التمثال الذي في البيت يُقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر فليقطع فيجعل منه وسادتان تُوطأان، ومُرْ بالكلبِ فليُخرَج)).
والنهي عن اقتناء الكلاب في البيوت ليس معناه القسوة عليها أو الحكم بإعدامها؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم، لأمرتُ بقَتلِها)).
فقد قص النبي صلى الله عليه وسلَّم على أصحابه قصة الرجل الذي وجد كلبًا في الصحراء يلهث (يأكل الثري) من العطش، فذهب إلى البئر ونزع خفَّه فمَلأها ماءً حتى رويَ الكلب، قال صلى الله عليه وسلَّم: ((فشكَر الله له، فغَفَر له)).
والمباح اقتناؤه من الكلاب ما كان للصيد أو لحراسة ما لا يُمكن حراستُه إلا بالاستعانة بالكلب لاتساع المكان المحروس، على أن يتمَّ إبعاده عن مخالطة أهل البيت.
وسبب امتناع الملائكة من دخول البيت وفيه كلب: كثرة أكلِه النجاسات، ولأنَّ بعضها تتلبَّس به الشياطين كما جاء به الحديث، والملائكة ضد الشياطين، ولقُبحِ رائحة الكلب، والملائكة تكره الرائحة القبيحة، هذا فضلاً عما أثبَتَه العلم الحديث من وجود الدودة الشريطيَّة في لعاب الكلاب، التي قد تؤدي بحياة المصابين بأمراض، ممَّن يُداعبون الكلاب ويُقبِّلونها، ويَسمحون لها بلمس أيدي الصغار والكبار.
الثالثة: اهتمام الإسلام بالتشجير والزراعة لحماية الأرض من التلوث:
وقد تجلى هذا الاهتمام في أمرين:
الأول: تهيئة الله عزَّ وجل الأرض للإنبات والزرع بجعلها ذلولاً وبساطًا، فهي نعمة من الخالق أسبغها على خلقِه، يجب عليهم أن يذكروها ويَشكروها ويُحافظوا عليها؛ قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: 19، 20]، وقال أيضًا: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ * فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ * وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ * فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: 10 – 13]، وقال كذلك: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ * تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ [ق: 7، 8].
الثاني: الحث على الغرس والزَّرع حتى آخر لحظة من عمر الدنيا؛ فمِن سَعة الله ورحمته وكرمه الذي أكرم به عباده أنْ حثَّهم على لسان نبيه باستمرار الغرس والزرع حتى يُثيبهم عليه، سواء كان مأكولاً أو مُنتفعًا به، ولو مات غارسُه أو زارِعه، ولو انتقل إلى ملك غيره، وهذا الثواب ينتفع به في الحياة وبعد الممات؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّم: ((ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه (ينقصه) أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة))، وفي رواية له: ((فلا يَغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابَّة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة))، وفي رواية أخرى له: ((لا يغرس المسلم غرسًا ولا يزرَع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة))، وقد روي أن رجلاً مرَّ بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يغرس جوزة فقال: أتغرِس هذه وأنت شيخ كبير وهذه لا تُثمر إلا في كذا وكذا عامًا؟ فقال أبو الدرداء: ما عليَّ أن يكون لي أجرُها ويأكل منها غيري؟
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلَّم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَّم يقول بأذني هاتين: ((مَن نصَب شجرةً فيصبر على حفظها والقيام عليها حتى تُثمِر، فإنَّ له في كل شيء يُصيب مِن ثمرها صدقة)).
وبلغ من روعة الإسلام وحرصه على التشجير أنْ حثَّ على غرس الفسيلة والساعةُ قائمة، والحياة مولية، ولن ينتفع بها أحد، لكنه جعل هذا الغرس عبادةً لله حتى آخر لحظات الدنيا؛ فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلَّم: ((إذا قامت الساعة وفي يدِ أحدِكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها))؛ رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد.
الرابعة: هدْي الإسلام في المحافظة على الأشجار والثمار حتى في حالة الحروب:
وقد تجلى ذلك في وصية الخلفاء الراشدين الذين تربوا في مدرسة النبوة بالحرص على البيئة وعدم قطع الأشجار أو ذبح الشياه والبَعير، إلا لمنفعة، فها هو أبو بكر الصدِّيق رضي الله عنه حين بعَثَ أسامة بن زيد إلى بلاد الشام يُوصيه وجندَه قائلاً لهم:
“لا تخونوا، ولا تغلُّوا، ولا تغدروا، ولا تُمثِّلوا، ولا تَقتُلوا طِفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأةً، ولا تَعقروا نخلاً ولا تَحرقوه، ولا تقطعوا شجرةً، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة”.
ولما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بني النضير، كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في نَخيلهم؛ إهانة لهم وإرعابًا لقلوبهم، فقالوا: ما هذا إلا فساد يا محمد؟ إنك كنتَ تَنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [الحشر: 5]؛ أي: ما قطعتُم أيها المؤمنون من شجرة نخيل أو تَركتُموها كما كانت قائمةً على سوقها، فبإذن الله وإرادته ورضاه؛ ليغيظ اليهود ويُذلَّهم بقطع أشجارهم ونخيلهم.
ويعيب الله عزَّ وجلَّ في كتابة العزيز على من يَسعى في أرضه بالفساد والإفساد، فيَعتدي على البيئة بقطْع الأشجار المُثمِرة، ويتوَّعده بأليم العذاب وشديد العقاب؛ فقد رُوي أن الأخنس بن شَرِيق أتى النبي صلى الله عليه وسلَّم فأظهر له الإسلام وحلَف أنه يُحبه، وكان منافقًا حسن العلانية خبيث الباطن، ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلَّم فمرَّ بزرعٍ لقوم من المسلمين وحُمُر، فأحرق الزرع وقتل الحمُر، فأنزل الله تعالى فيه الآيات: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [البقرة: 204 – 206].
هذا هو منهج الإسلام في المحافظة على البيئة من تلويثها بالقمامة، حتَّى لو كانت هذه البيئة ملكًا لغير المسلمين، فإن الأمر بالمحافظة عليها أمر إلهي لا يَجوز مخالفته إلا في حالة استثنائية أوضحناها سلفًا، وما هذه المحافظة على البيئة من جانب الإسلام إلا لكونه دينَ السلام مع الله ومع الناس ومع جميع الكائنات.
المراجع:
مؤلف ( البيئة والتلوث من منظور الإسلام )
للدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
طبعة دار الصحوة بالقاهرة 1993
• قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة؛ د. ماجد راغب الحلو.
• شرح قوانين البيئة؛ للدكتور: عبدالفتاح مراد.
• قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994.
• جرائم تلوث البيئة في القانون الليبي دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، فرج صالح الهريش، مكتبة كلية حقوق القاهرة، سنة 1997.
• حماية البيئة من النفايات الصناعية؛ د. عبدالعزيز مخيمر.