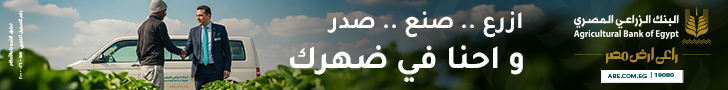رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن الثقافة التربوية
بقلم / المفكر العربي الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
ورئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
الثقافة التربوية
تعريف الثقافة:
لغة: ثَقَف: غلام لَقِنٌ ثَقِف، أي ذو فِطْنة وذكاء. ورجُل ثَقِفٌ وثَقُفٌ وثَقْف. والمراد أنه ثابت المعْرفة بما يُحْتَاج إليه.[1]
اصطلاحاً: الثقافة هي مجموع العقائد والقيم والقواعد التي يقبلها ويمتثل لها أفراد المجتمع. ذلك أن الثقافة هي قوة وسلطة موجهة لسلوك المجتمع، تحدد لأفراده تصوراتهم عن أنفسهم والعالم من حولهم وتحدد لهم ما يحبون ويكرهون ويرغبون فيه ويرغبون عنه كنوع الطعام الذي يأكلون، ونوع الملابس التي يرتدون، والطريقة التي يتكلمون بها، والألعاب الرياضية التي يمارسونها والأبطال التاريخيين الذين خلدوا في ضمائرهم، والرموز التي يتخذونها للإفصاح عن مكنونات أنفسهم ونحو ذلك.
الثقافة التربوية:
” مجموعة المعلومات والخبرات التي نحتاج إليها في تكوين البيئة التربوية، وفي طريقة تهذيب الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة، وفي التعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم، وتعني الثقافة التربوية كذلك: فهم جوهر التربية وأنها قائمة على التفاعل وبناء الروح الجماعية، وما يتطلبه ذلك من مبادئ وقيم وتضحيات وأفكار ومفاهيم وهذه المكونات لن تكتمل أبداً؛ حيث سنظل نشعر بأننا نواجه مواقف تربوية، لا نعرف كيف نتصرف فيها على النحو المناسب، وما ذلك إلاّ لأن التربية عملية معقدة جداً، وتتطلب قدراً جيداً من المعرفة والحكمة، وقدراً جيداً من الاتزان الانفعالي لدى المربيّ، إلى جانب قدر من الخبرة والممارسة العلمية وإنّ كل ذلك لا يعني كثيراً إذا لم يصحبه شيء من توفيق الله تعالى وهدايته وتسديده وهذا ما لا يصح أنّ نغفل عن طلبه والدعاء به “[2].
مدخل إلى مفهوم التربية الإسلامية:
” لا مُشاحَةَ في أن الأولاد قرة عين الإنسان، ومصدر سعادته، وبهجة حياته بهم تحلو الحياة، ويطيب العيش، ويُستجلب الرزق، وتعقد الآمال، وتطمئن النفوس. وإذا كان الأب يرى في أولاده العون والفرد والتكاثر والامتداد وقوة الجانب، فإن الأم ترى فيهم أمل الحياة، وسلوى النفس، وفرحة القلب وبهجة العيش، وأمان المستقبل. وهذا كله منوط بحسن تربية الأولاد، وسلامة تكوينهم وإعدادهم للحياة، بحيث يكونون عناصر بنّاءة فعّالة، يعود خيرهم على والديهم، وعلى مجتمعهم، وعلى الناس أجمعين وبذلك يكونون كما قال الله تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ [الكهف: 46]. أما إن أُهملت تربيتهم، وأُسيئ تكوين شخصياتهم، كانوا وبالاً على الوالدين، وشراً مستطيراً على المجتمع”[3].
دأب العلماء والفلاسفة والمفكرين قديماً وحديثاً بالاهتمام بمفهوم التربية ووضع تعريف شامل لها، وظهرت نظريات كثيرة لمفهوم التربية الحديثة وأساليب تطبيقها.
” وقد أثبتت النظريات التربوية المجرّدة: أنها تحرّك الوجدان وحدها. إذ أنّ العلم والنظريات، والتحاليل النفسيّة، وغيرها لا توصل إلى تحريك مباشر للوجدان والضمير، أو إضافة قيم ومبادئ خُلقية سليمة بقدر ما يكون الدّين هو الأسلوب المباشر الناجح في تحريك المشاعر؛ لتنعكس على الواقع في شكل سلوكٍ معيّن، وخُلُقٍ قويم “[4].
وفي خضم هذه النظريات والأسس التطبيقية التي تتصارع للتنافس حول النظرية، الأفضل للتطبيق على جيل العولمة والتكنولوجية. نجد بأن العرب قبل الإسلام كانوا يهتمون بالتربية وإن كانت غير مقولبة في تعريف حرفي، أو نظريات واضحة، ورغم ذلك نجد بأنهم اهتموا بالتربية البدنية لأبنائهم؛ للدفاع عن القبيلة، كما اهتموا بالتربية الأخلاقية فتمتعوا بخصال كريمة كالكرم والشجاعة والإيثار، ونصرة المظلوم، والوفاء بالعهد… وغيرها من الخصال التي أثنى عليها الإسلام، وحض عليها النبي وأتمها بقوله صلى الله عليه وسلم : ” إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ” [5].
ومع بزوغ الإسلام بدأ المسلمون يسبغون على التربية الطابع الديني الإسلامي، لأن الإسلام جاء بالمنهاج المتكامل. ” وتركزت التربية الإسلامية في الفترة الأولى بعد الإسلام على الناحية الدينية والأخلاقية. فقد ظل الرسول في الفترة المكية قبل الهجرة النبوية يُربي أتباعه على القيم الجديدة التي أتى بها الإسلام. وظل الجانب العقدي والأخلاق هو الأهم حتى بعد أن اعتنى فيما بعد بجانب المعارف والمهارات”[6]. فالتربية الإسلامية تعمل على إيجاد الإنسان المتكامل، القوي، المهذَّب، المتصف بالخُلق الحميد، كما تعمل على إيجاد المجتمع السعيد، المستقر، الرائد في كل المجالات. حيث تعمل على الأصعدة كافة: العقائدية، والفكرية، والاجتماعية، والاقتصادية، و…؛ ولأن هذه التربية منبعها الإسلام الذي “رسم منهجاً متكاملاً يتناول الإنسان من جميع جوانبه، بحيث لو طُبّق تطبيقاً سليماً لخرج للمجتمع الإسلامي المسلم المتكامل السوي الذي يستطيع أن يحقق هدف الإسلام من التربية، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان فهو أعلم باحتياجات الإنسان الجسمية والنفسية والاجتماعية “[7] والاقتصادية.
تعريف التربية الإسلامية:
” وفي التربية الإسلامية نتجه في تعريفها نحو تلك التربية التي تجسد القرآن والسنة النبوية نصاً وروحاً، أهدافاً ومنهاجاً، أسلوباً وطريقة، قدوة ومثالاً، وكانت هذه تربية عهد النبوة والصحابة والتابعين، أما بعد ذلك تنوعت الثقافات وتعددت المشارب، ففتحت الأبواب لأفكار وأساليب، ومناهج وطرق قد تكون دخيلة على الإسلام، فتنسب إلى المسلمين لا إلى الإسلام، علماً بأن نعمة الإسلام لم تنطفئ “[8].
هنالك تعاريف كثيرة لمفهوم التربية الإسلامية ومنها:
• ” تعبير يُقصد به تنشئة الفرد المسلم والمجتمع الإسلامي تنشئة متكاملة يُراعى فيها الجانب الروحي والمادي في ضوء النظرة الإسلامية الشاملة، وهي تُعنى بالفرد وإعداده لحل مشاكله، ومدى نجاحه في تحقيق رغباته المشروعة التي تضمن له حياة هانئة في الدنيا والآخرة “[9].
• وهي: التربية التي تجمع بين” تأديب النفس وتصفية الروح، وتثقيف العقل، وتقوية الجسم، فهي تعني بالتربية الدينية والخلقية والعلمية والجسمية، دون تضحية بأي نوع على حساب الآخر “[10].
• ” مجموعة المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد يستند إلى المبادئ والقيم التي أتى بها الإسلام والتي ترسم عدداً من الإجراءات والطرائق العلمية يؤدي تنفيذها على أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة الإسلام “[11].
فالتربية ليست نظرياتٌ تُوضع، ولا شعاراتٌ تُرفع، ولا مناهج تُدرس؛ بل هي عملية تلقين تثُير قوة التفكير، وتُحرك الدوافع النفسية، وتستخرج الفطرة الجبلية لتبني الإنسان السوي بسلوكه وممارستها اليومية المستمدة من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية.
والتربية وإن بدت للبعض عملية سهلة، أو مجموعة من القواعد والقوانين تُحفظ وتُطبق، على العكس تماماً، فالتربية عملية غاية في التعقيد لأنها تستلزم جهود جبارة لتربية الأبناء، فالمربي يتعامل مع كائن مليء بالمشاعر والأحاسيس، كائن متقلب بالأمزجة والأهواء، يتأثر بمن حوله سلباً وإيجاباً. ” إن ولادة طفل هي أكثر بكثير من حدث بيولوجي، وتتطلب إيجاد نظام اجتماعي جديد يمنح الطفل فرصة للحياة والتطور الذهني والجسدي والعاطفي والنفسي فالطفل كالشجرة يمكن التحكم في طريقة نموها بيسر، وهي غرسة صغيرة غضة في حين يصعب ذلك فيما بعد عندما تكبر ويقسو عودها “[12]. ” فالطفل أمانة بأيدينا ولا حِفاظ على هذه الأمانة إلا بالتربية الحسنة، فالاستثمار في تربية الأطفال هو أنجح وأسرع استثمار لأي مجتمع يُخطط لمستقبل حضاري وإذا كانت تحيى بالتجديد، فإن هذا التجديد لا يقوم إلا على حسن تربية النشء الجديد فإذا كانت التربية قيد من جانب، فهي فسحةٌ من جانب آخر… والتربية هي عمل واعٍ دؤوب هدفه تنمية الفطرة لبناء الإنسان المتعادل فكريّاً وروحيّاً وخلقياً وجسدياً، الإنسان الصالح في ذاته، المُصلح لأمته. فهي إذن فنٌ وعلمٌ ووعيٌ وجهاد. وإن الوالد الصالح هو الذي يُحسن تربية ولده، حتّى يكون أفضل منه، وتحتاج التربية إلى تكامل وتواصل كلّ الجهود، إذ يشترك المهد في البيت، والمقعد في المدرسة، والمنبر في المسجد، في صياغة الإنسان الهادي المهتديّ.
كما تنطلق العملية التربوية ابتداءً من اللحظة الأولى من عمر الإنسان، بتبليغ الوليد مبادئ الإسلام بسُنّة الأذان في أُذُنه، كيما تتشرّب روحه هذه الكلمات الخالدات، التي تُنجده عندما تعصف به الحياة وفي هذا الأذان إشعارٌ بأنّ الطفل قد اكتملت إنسانيته، فهو أهلٌ لتلقّي أعظم المبادئ في الوجود، وفيه أيضاً إيذانٌ للمربي بأنّ مهمته التربوية قد ابتدأت من هذه اللحظة، وكثيراً ما تكون الخطوة الأولى هي أهم عمل في مسير طويل…”[13].
فالعملية التربوية تبدأ منذ اللحظة الأولى لولادة الطفل، وعلى الوالدين تشمير الساعدين، مع الاستعانة بالله والتضرع إليه للعون على القيام بهذه المهمة العذبة الشاقة، وإن كانت التربية تختلف في طريقة تطبيقها وفقاً للمراحل العمرية التي يمر بها الطفل. حيث يمرّ الإنسان بأربعة مراحل في حياته وهي: مرحلة الفطرة وتبدأ من الولادة إلى سن السابعة، ثم مرحلة التمييز وتبدأ من السابعة إلى العاشرة، ثم مرحلة المراهقة وتبدأ من العاشرة حتى البلوغ، ثم مرحلة البلوغ وتبدأ من البلوغ حتى الموت. وتختلف العملية التربوية من مرحلة إلى أخرى، ولكل مرحلة معطياتها وحاجاتها ومشكلاتها. والمرحلة الأهم في تربية الأطفال تبدأ بمرحلة الطفولة المبكرّة من عام الفطام إلى نهاية العام السادس أو السابع من عمر الطفل، وهي من أهم المراحل التربوية في نمو الطفل اللغوي والعقلي والاجتماعي وهي مرحلة تشكيل البناء النفسي الذي تقوم عليه أعمدة الصحة النفسية والخلقية، وتتطلب هذه المرحلة من الأبوين إبداء عناية خاصة في تربية الأطفال وإعدادهم ليكونوا عناصر فعّالة في المحيط الاجتماعي، والتربية والتعليم في هذه المرحلة يفضّل أن تكون بالتدريج ضمن منهج متسلسل متناسباً مع العمر العقلي للطفل، ودرجات نضوجه اللغوي والعقلي. ” فالطفولة هي المرحلة التي تفصل الولادة عن هيجان البلوغ.
وتنقسم إلى عدة مراحل:
• الطفولة الأولى: تمتد حتى نهاية السنة الثانية.
الطفولة الأولى تتطبع مع الوعي، يعي الطفل أكثر فأكثر، إنه مستقلّ عن أهله رغم الشعور الواضح بأنه بحاجة إلى مساعدتهم في كل شيء. هذه الازدواجية ستطغي على حياته النفسية الانفعالية، وما سنو حياته الأولى سوى محاولات لاكتساب إمكانيات جديدة. وفي هذه المرحلة تبدأ مهارات الطفل العقلية والنفسية بالنمو.
• الطفولة الثانية: تمتد من السنة الثالثة حتى السادسة.
في هذا العمر يتعلّم بسرعة، وتتم نقاط عصبية مشتركة بإيقاع سريع جداً في دماغه الطري. فيزداد حس الاكتشاف لديه. إنه عمر سلسلة الأسئلة التي لا تنتهي، وحس الملاحظة يزداد، وكذلك حس التقليد. فيبدأ بتقليد الكبار. فلهذه السنين الأولى أهمية كبرى من حيث التعلّم وتكوين طبعه.
ويمكن القول أنّ حوالي السن الرابعة، يُنهي الولد تعلّمه، ممّا يعني أنه ابتدأ من هذه المرحلة يملك في ذاته كل القدرات التي بنمّوها تكوّن طبعه. ويبدأ بأن يكون له آراؤه الخاصة ويشعر بحيرة بادئ الأمر ثم بوضوح أكثر، ضرورة تكيّفه مع الشرائح الاجتماعية في المحيط الذي يعيش فيه.
• الطفولة الكبرى أو المرحلة المدرسية: تمتد حتى سن البلوغ.
بعد السن السادسة وحتى الحادية أو الثانية عشر يبطؤ النمو الجسدي الذي كان سريعاً في البداية وكأنه في راحة. يصبح الطفل تدريجياً أقل ارتباطاً بأهله ويتطور بالمراقبة الذاتية. عندئذ يبدأ التملص خارج دائرة أهله المحدّدة، نحو المجتمع، ثم تبدأ المرحلة المدرسية، ليحقق انخراط هذا الشاب في المجتمع. تبدأ المدرسة بالتعليم، ويلاحظ الأهل أن المعلمين بدؤوا يحلون محلهم تدريجياً، استقلال الولد يعبّر عنه عندئذ بعادات سيئة وأحياناً بالتمرد ضد سلطة الأهل. حيث ينقل البعض التصرف من سائر الأولاد الذين يعاشرهم. فهكذا تنظم المجموعات والأندية بقدر ما يميل الأولاد نحو الحياة الجماعية. في هذه المرحلة ينمو الإدراك والذكاء، ويصبح التعلّم مع الفهم.
• المراهقة:
هي مرحلة الحياة التي تلي الطفولة وتمتد حتى سن الرشد. تبدأ المراهقة مع سن البلوغ حوالي الحادية أو الثانية عشر عند البنات، وحوالي الثالثة أو الرابعة عشرة عند الصبيان. نظرياً تنتهي حوالي الثامنة عشرة عند الفتاة وفي العشرين عند الشباب، وهذه المرحلة لا تتعلق فقط بالجنس، إنما أيضا تتعلق بالمناخ، بالوراثة، بالغذاء وبالمحيط النفسي والاجتماعي، فليس من دون سبب تسمى المراهقة: السن الناكر الجميل وهي بالفعل تطابق اضطراباً عميقاً لوظائف الجسم وبخاصة الوظائف الجنسية التي تترافق مع تغير مواز للطبع. يمكن أن تظهر اضطرابات نفسية وجسدية خلال هذه المرحلة ولكنه بالعموم غير خطرة إذا وجد المراهق حوله أهله، معلميه ليساعدوه في ما هو بحاجة إلى معرفته”[14].
________________________________________
[1] الأثير، النهاية في غريب الأثر، باب الثاء، فصل القاق، 1، 625
[2] بكار، عبد الكريم، القواعد العشر (أهم القواعد في تربية الأبناء)، دار السلام، القاهرة، 1430هـ/ 2009م، 8.
[3] الهاشمي، محمد علي، شخصية المرأة المسلمة، الرياض، وزارة الشؤون الإسلامية، 1425هـ /2005م، 46.
[4] بديوي، يوسف وقاروط، محمد محمد، تربية الأطفال في ضوء القرآن والسنة، 2، 706.
[5] ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ / 855 م)، المسند، تذيل شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة قرطبة، د.ت، [1- 6]، 2، حديث (8939)، 381.
[6] الموسوعة العربية العلمية، حرف التاء.
[7] فهيم، مصطفى، منهج الطفل المسلم، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1424هـ/ 2003م، 7.
[8] سعد الدين، محمد منير، دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين، بيروت، دار المحروسة، ط 2، 1415هـ/ 1995م، 10.
[9] الموسوعة العربية العلمية.
[10] الأهواني، أحمد فؤاد، التربية في الإسلام، القاهرة، دار المعارف، 1400هـ/ 1980م، 9.
[11] سعيد، إسماعيل علي، مصادر التربية الإسلامية، القاهرة، عالم الكتب، 1436هـ/ 1973 م، 1، 169.
[12] إبراهيم، عبد الرحمن، كيف نفهم الطفل والمراهق؟ ، حلب، شعاع للنشر، 1428هـ/2007م، 15.
[13] الدالاتي، عبد المعطي، عِطرُ السماء حداء للبنين والبنات، دمشق، مؤسسة الرسالة، ط 3، 1423 هـ / 2002 م، 12.
[14] عازار، سمير، الموسوعة الصحية الشّاملة، أعضاء وأجهزة (2)، تعريب قسم الدراسات بإشراف الأستاذ افرام غزال، دار نوبلس، ط1، 1425هـ/2005م،[1- 8]، 3، 98 وما بعدها، بتصرف.
: