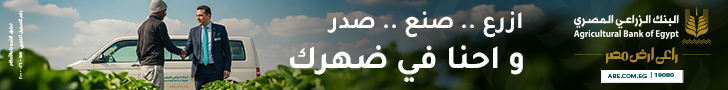“عودة نرسيس”
قصة قصيرة
بقلم /الأديب التونسي د. المنذر المرزوقي
رأى نفسه جميلا، فلم يستطع أن يصنع الجمال، ابدا.
لم يفهم سببَ الغواية التي تُراوده منذ شهور. ولا كيف تحوّلت رغبته، في الأيّام الأخيرة، إلى نزوة مُلحّة أصابته بالقلق والأرق. وهكذا خضع لها، وقرّر أخيرا، أن يزور نفس البحيرة التي اكتشف فيه ذاته الرائعة، قبل سنوات طويلة.
خرج فجرا، دون أن يجد الوقت الكافي ليُخبر أحدا برحلته. خرج من باب المدينة، جهة المُرتفعات. ثمّ أوغل في المسالك الخلفيّة والثنايا الضيّقة، حتّى أدرك قمّة الجبل، فأشرف على القرى المتناثرة والسّهول الواسعة. أخذ قسطا من الرّاحة، في ظلّ شجرة عالية، كثيرة الأغصان كثيفة الأوراق. ومن مُرتفعِهِ ذاك، لمحَ النّهرَ بمائه المُلتمع الصّافي المُنسابَ في لين، نحو البحيرة، ثمّ التفتَ، سعيدا راضيا، إلى قريتهِ النائمة بين الرّبى والسّهول، هناك.
داعب النسيمُ جسده المتعبَ، وراود النّعاسُ أجفانه، فغفا، مبتسما لصورة وجهه المُبهرة في الماء المرآويّ. لم ير غير نفسه في الماء، ولم يبصر إلاّ ذاته في النّاس. كان يمشي مرحًا، أو يقفُ شامخًا، أو يجولُ مُختالاً بين البشر. كان ينظر إليهم من علٍ، فيُلامسُهم بأطراف ثوبه، ولا يرى إلاّ عيونَهم الشّاخصة وملامحهم المندهشةَ. وكان “نرسيس” لا يعلم، على وجه اليقين، إن كان واقعهُ حلمًا، أم كان حُلمهُ واقعًا. لأنّه لم يكن راغبًا في الفهم والفصل، مادام يَعبُرُ بين الإثنين، مُمتلئا فَخورا، مُكتفيا بحقيقته، سَعيدا بيقينه.
استفاق مُبتسما، أو هكذا بدا له، ونزل من الجبل نشطا سعيدا، متتبّعا مجرى النّهر، أو هكذا ظنّ. وحين أدرك ضفّة البحيرة، أسرع إلى الماء، ليلتقي بذاته. لكنّه لم ير شيئا. لم ير وجهه. فهل ابتلع الماء صورته؟ أم أضحى حفرة بلا قاع؟ نظر مُرتعبًا.. تفرّسَ وجلاً.. خافَ من صُورة شخصٍ آخر في الماءِ. شخص غريب لا يعرفه.
أغمض عينيه. غسل وجهه. ثم نظر في مرآة الماءِ اللُّجينِ من جديد، لكنّهُ رأى ذات الشخصِ الغريبِ الكريهِ. ضرب في الماء بكلتا يديه، تجعّد الوجهُ في الدوائر وارتفع مع قطرات الماء. أرعبته ملامح الوجه القبيحِ، فانتفض واقفًا. عدا مُرتعبًا في الثنايا والمرتفعات. كان يُغمضُ عينيه، كي لا يرى ويفتحُها، كي لا يُخمّن في هواجِسه. ويعدو متعثّرا في دُروب الحصى والشوك، ولا يتوقف، حتّى لا تستقرّ صورةُ الشخص الغريب الكريه في ذهنه، ولا تثبت في عينيه.
ضرب على رأسه، بكلتا يديه، ليُسقط الصورةَ الكريهةَ من ذاكرته السّعيدة، حتّى يدُوسَهَا ويُهشّمَهَا، تحت أقدامه الدّامية. قضّى ساعات وهو يجري.. يهوي.. يتعثّر.. يعدو.. يترنّح، حتّى أدرك الشجرة في القمّة. اقترب من جذعها، جَثا على ركبتيه. حبَا نحوها، ثمّ أسند ظهره إليها علّه يغفو. أو يتنفّس ملء صدره، أو ينام قليلا، على سعادته القديمة بذاته.
لكنّ النومَ، مثل الماء، غدر به، تخلَّى عنه، ليتركه وحيدًا في مُواجهة الصّورة المرعبة للشيخ الأشيب الذي أطلّ عليه من صفحة الماء. شيخٌ تهدّل وجهُهُ وارتخَى جلدُ خدّيهِ وأحاط السوادُ بعينيه المُحمرّتين المُنهكتين. كان الوجه الغريب نحيلا مصفرّا، بأنف طويل وشعر رماديّ يميل إلى بياض، وجبين عَلَتهُ الغضون.
تلمّسَ وجهَه، تحسّسَ التجاعيدَ، ومرّرَ يدهُ المرتجفةَ على بقايا شعره الأشيب. وحين أدرك أنّ الوجهَ الكريهَ قد التصق به إلى الأبد، صاح ملء صدره مُرتعبًا. فانتبه لنفسه يصيح، فزعًا، تحت الشجرة العظيمةّ المُطلّة على النّهر هنا، وعلى مدينته هناك.. قرّر أن يكسرَ المرآةَ، ألّا يعود إلى البحيرة، أن يَهجرَ النّاسَ دائما، وينسحب إلى ذاكرته، حتّى يعيشَ مع صورة وجهه الحبيب، ولِهًا، هائمًا، أبدًا.
لكن نرسيس لم يهنأ أبدا بقراره. فقد أخذت مُنيمُوسينا الماكرة تطاردهُ ليلا ونهارا، وفي كلّ مكان حاول الاختباء به. كانت تتقفّى آثاره في الوديان والأحراش وتتتبّعه في السّهول والغابات وتحاصره في الكهوف والمهاوي، حتّى لا تترك له فرصة أن يهرب أو ينسى.
كذا قضّى أيّامه وسنواته الموحشة هاربا منها، ومن صورة تشير بها إليه ساخرة. من صورة علقت بوجهه ولا يريد أن يراها. وفي يوم غريب، مثل هذا، طاردته الماكرة لساعات. وحين حاصرته أخيرا، فوق صخرة في القمّة العالية، ولم تترك له منفذا للهروب، هوى نرسيس نحو البحيرة المرآويّة. لكنّه لم يصل إلى قاعها مطلقا. لقد بقي مُعلّقًا، أبدا، بين الماء والسّماء. تُراقِبهُ منيموسينا، من فوق صخرة النسيان الشاهقة، ساخرةً، وترقُبُهُ البحيرةُ، في القاع العميق، حتّى يرى حقيقتهُ في الماء المرآويّ، عاريةً.