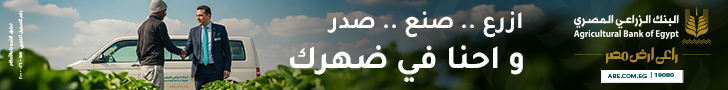بقلم الكاتبه والأديبة / سلوى مرجان
الفصل الأول :
منذ سنوات توفت ابنته التي لم تتجاوز الرابعة بعد رحلة قصيرة مع السرطان، كادت زوجته أن تجن، فنقل عمله إلى مدينة ساحلية بعيدة، لربما تجد سلوتها بين البحر والسماء.
لكن حساباته كانت خاطئة، فما هي إلا أياماً قليلة حتى ألقت بنفسها في البحر واستسلمت لأمواجه ولم تكلف نفسها عناء مصارعته.
وحيدا ما بين صوت الريح وصوت الموج قضى الليالي، أما في الصباح فيذهب للمدرسة، ليقص على الصغار أكاذيب التاريخ. إلى أن بدأ الفصل الدراسي الثاني ووجدني أمامه طالبة جديدة تجلس بين الطلاب وتبدو أصغر سناً منهم، سألني عن اسمي وسني، فأجبت أن اسمى (لوز) ولم أكمل بعد عامي العاشر، وكان وقتها في السابعة والعشرين من عمره. وبعدما أجبته ألقيت بشعري المنسدل على كتفي إلى الوراء بخيلاء مثيرة للضحك.
الصدفة العجيبة أنني سكنت بجواره، لمحته أكثر من مرة ولم يلمحني، وذات يوم وقبل المغرب بقليل بدأت اللعب أمام ساحة بيته، كنت أقلد صوت الطيارة: فووووووووووم فووووووووووم فووووووووووم فووووووووووم فووووووووووم
لم أتوقف أبدا عن إصدار الصوت، كنت أتعمد ذلك ولا أدري سببا وقتها، ونجحت خطتي واضطر للخروج لرؤية صاحب الصوت، كنت أركب دراجتي ذات العجلات الثلاث ممسكة بيدي خيط الطائرة الورقية وأجري بصورة دائرية والطائرة ترفرف في السماء. بدا عليه الغيظ الشديد، لكني عالجته بسرعة بابتسامة ولوحت له صائحة: مرحبا معلمي.
فأفلت الخيط من يدي وطارت الطائرة لبعيد.
وضع يده بسرعة فوق أذنه، فسألته : ما الأمر؟.
نظر لي بدهشة وقال : خيبت توقعاتي، ظننتك ستصيحين.
وقتها لم أفهم كلامه، لكني أوقفت الدراجة وأشرت للسماء: انظر إنها ترحل بعيدا ناحية الشمس.
نظر للطائرة التي طارت بعيدا بفعل الهواء الشديد، ثم تابعناها حتى سقطت في البحر.
عند هذا الحد نظر لي وقال: لوز يا صغيرتي أستطيع عمل طائرة ورقية لك.
بدأت أتحرك بالدراجة مرة أخرى وأجبت: لا أريد، سأبحث عن لعبة جديدة.
قال بدهشة: لكنك كنت تستمتعين بها وأنا أستطيع عمل واحدة لك.
أجبت بعدم اكتراث: لقد أعطيتها هدية للشمس.
قال: لكنها وقعت في البحر.
رددت ببساطة: إذا هي ابنة البحر وعادت له.
ثم أسرعت بعجلتي وأنا أصدر صوت البوق بفمي.
مرت الأيام ونحن على هذا الحال كل يوم بعد عودتي من المدرسة، ألعب بعجلتي وأصدر أصواتا بفمي حتى تغرب الشمس فأدخل بيتي.
حتى جاء يوم ذكرى وفاة ابنته، وبدا في حالة سيئة، كنت ألعب وقتها بنفس الضوضاء اليومية، فخرج لي وقال بعصبية: لوز لا أريد إزعاجا اليوم.
نظرت له نظرة خاطفة ثم تحركت بعجلتي بعيداً وأنا أتمتم: أمرك معلمي.
في اليوم التالي فهمت الأمر من ثرثرة المعلمين، وأشفقت عليه رغم صغر سني، ولسبب غير مفهوم أصبحت أتحاشاه وأخاف من إغضابه، لكني كنت أتلصص عليه من بعيد.
وكبرت… صرت ابنة العشرين، أما هو فكان في السابعة والثلاثين، كرس حياته للعمل والقراءة أمام البحر.
كنت ألقي عليه السلام كلما رأيته، برعشة لا يعلم عنها شيئا، كنت أتظاهر بالخروج في موعد عمله، أهجر الجامعة كل اثنين لأن هذا هو اليوم الذي يجلس فيه ساعة على البحر قبل الذهاب لعمله.
أراقبه من بعيد وأخشى الاقتراب، أستمع لأخباره من المحيطين واضطرب عندما تقترب أي امرأة منه.
أما هو فكان يناديني ب (صغيرتي), ألم يلحظ أن عيوني صارت تهرب منه، عندما كنت صغيرة كنت أنظر له ملء عيني، أما الآن بعدما صار يحتلني أصبحت أخشى أن تلتقي أعيننا فيفتضح أمر ذلك القلب.
ذلك الصباح عندما كنت أتأبط كتبي ذاهبة للجامعة، وجدته يمضي بآخر الشارع، أسرعت الخطى لأخلق لقاء، لكن خطواته كانت أسرع، وقبل أن ألحق به كان يركب سيارة الأجرة.
وقفت أمام الريح تفعل بي ما تشاء، وأحسست أنه أبعد ما يكون، هو هناك حيث رحلت ابنته وزوجته، وأنا هنا منذ التقينا وطارت الطائرة ليبتلعها البحر.
بعدها بيومين التقيته على شاطئ البحر يطالع كتابا كعادته، وقفت على مقربة وهمست: مساء الخير أستاذي.
رمقني بنظرة سريعة قبل أن يضع الكتاب من يده ويبتسم بهدوء قائلاً: مرحبا صغيرتي لوز، كيف حال الجامعة؟
قلت وانا أقترب خطوة واحدة: الجامعة بخير، ولا بأس إن سألت عن حالي أنا.
تأملني لثوان قبل أن يقول: ما زلت مشاغبة.
ثم أشار لي لأجلس، فجلست ونظرت بعيدا، وشعرت بنظراته تتجه لي، فتشجعت وسألته: لماذا لم تتزوج أستاذي؟
تنهد قبل أن يجيب: العكاز يحتاجه المصاب بقدمه، أما المصاب بقلبه فلا تكفه الدنيا ليتعكز عليها.
_ لقد مضى وقت طويل أستاذي.
_ بعض المصائب تحتاج عمرا جديدا لننساها.
_ وبعضها ننساها بأشخاص آخرين.
_ إن أردنا يا لوز، وأنا لا أريد.
للحظة لم أنطق، ثم أدركت أنه كما قال (لا يريد), وما دام لا يريد فلن يجدي الكون كله معه.
الفصل الثاني :
تيقنت أن علي الابتعاد، وأعددت العدة لهذا الأمر، فعلت عكس ما كنت أفعل، ابتعدت عن الأماكن التي قد ألتقيه بها، هجرت أوقاته، خاصمت البحر، وذهبت الجامعة يوم الاثنين.
ومنذ ذلك الحين وأنا أراه أضعاف ما مضى كله.لكني تظاهرت بعدم رؤيته، وقلبي يئن من وطأة هذا البعاد.
ذات نهار شديد البرودة طلبت من أبي توصيلي للجامعة بسيارته، وبمجرد أن ركبنا السيارة هطلت أمطار غزيرة، أمرني أبي بغلق النافذة بسرعة، وأثناء ذلك لمحته يخرج من بيته، لكن يبدو أنني لست وحدي من لمحه، فأبي أخرج رأسه من النافذة وصاح:
_ أستاذ محمود، أركب بسرعة.
اقترب محمود من السيارة وقال بصوته الهادئ:
_ صباح الخير، لا داعي، اذهبوا أنتم لعملكم.
رد أبي بإصرار:
_ لا عطلة أبداً، لن نتحرك بدونك.
ثم أشار لي أبي لأجلس بالخلف، ففتحت الباب ولم أنظر له على الرغم من وقوفه أمامي تماماً، وبسرعة فتحت الباب الخلفي ودخلت.
عندما جلس بجوار أبي، بدأ الأخير يسأله عن حاله وأخباره، ومحمود يرد بمقدار السؤال، حتى قال أبي له:
_ الشتاء قارس هذا العام، لن نتركك وحدك به، لقد طلبت منك طيلة السنوات الماضية أن تنضم إلينا في الغداء ولو ليوم في الأسبوع وأنت كنت ترفض، لكن لا مفر لك هذا العام.
ابتسم محمود وقال:
_ أنا أعلم نقاء سريرتك سيد أشرف، ولكن لا أحب التطفل على حياة الآخرين
أجاب أبي بسرعة:
_ دعك من هذا الكلام، أما مللت البقاء وحدك؟!
_ لقد اعتدت على الوحدة.
_ لا أحد يعتاد على الوحدة، تعالى لتتعرف على أخي الأصغر، فهو قد أصبح مدير فرع الشركة هنا، لذلك سيمكث معنا حتى نهاية الشتاء ريثما ينتهي من إعداد بيته.
أنزلنا محمود أمام المدرسة بعدما وعد أبي بالمرور وقت الغداء.
في هذا اليوم بكيت كثيرا ولم أكن أفهم سر هذا البكاء، لكني عدت مبكراً من الجامعة وجلست أحضر الغداء مع أمي، واهتممت خصيصا بحساء الدجاج الذين كنا جميعا نحبه.
الأمطار لم تتوقف وأبي وعمي عادا سوياً بعد العصر، وبمجرد دخولهما أشعل أبي المدفأة وجلس بجوارها، في حين قفزت أختي الصغيرة على قدمه وحضنته لتستمد منه الدفء، بينما أتخذ أخي الكبير وعمي ركناً ليثرثرا به في انتظار الغداء.
أزحت الستائر من أمام النافذة ووقفت أنظر ناحية بيته، لكني لم ألمحه…. حتى سمعت أبي يقول لاخي:
_ أذهب لمحمود وأخبره أننا بانتظاره.
وما هي إلا دقائق حتى عاد أخي ومعه محمود….. وضعنا الطعام وبدأ الجميع بالحساء الذي أسقطت به عن عمد الشطة، فكانت ردة الفعل الأولى من أبي الذي صاح:
_ لوز لقد وضعت الكثير من الشطة في الحساء.
قبل أن أنطق تذوقت أمي الحساء وراحت في نوبة من الضحك، أما أنا فلذت بالصمت، وأبعد عمي الحساء وهو يقول:
_ لا أتخيل أن علبة الشطة وقعت كلها دون قصد منك.
هنا التقطت أمي طرف الحديث قائلة:
_ جدتك كانت تقول دوما أن المرأة إذا أرادت جذب انتباه رجل وضعت له الشطة في الطعام.
احمر وجهي ووضعت عيني في طبقي، حيث أن هذه كانت نيتي بالفعل، لكني شعرت أن محمود ما زال يتناولها ولم يتوقف، وهنا قال أبي:
_ دعك من الحساء
أجاب محمود بهدوء:
_ أنا أحب الشطة بالطعام.
وعندما انتهينا من الطعام كان البرق والرعد على أشده، فقالت أمي بحماستها الدائمة:
_ الآن وقت أم علي والاستماع للست.
فصفق عمي وهز قبضته قائلاً:
_أعشق برامجك الشتائية.
جلسنا جميعاً في الغرفة الصغيرة، وكنا نطلق عليها غرفة الشتاء لأن نوافذها محكمة الغلق وستائرها من القطيفة الثقيلة وبها مدفأة من الحجر نشعلها بالأخشاب كما العصور القديمة، في حين أتت أمي بأم علي، أما عمي ففتح الست تمام الخامسة فصدحت(فكروني), جلست أنا بجانب عمي، وجلست الصغيرة كالعادة على قدم أبي، وبدأنا جميعاً نثرثر،ومع الوقت شعرت أن محمود أسعده هذا الجمع فبدأ يتكلم بأريحية أكثر، كل هذا وأنا أتحاشى النظر له مباشرة.
تركنا في هذا اليوم الثامنة مساءً على وعد أن نجتمع كل أسبوع.
وفي صباح اليوم التالي خرجت باكرا من البيت، وبعد خطوات سمعت صوته خلفي تماما يقول:
_ يبدو أنني لست مرغوبا.
توقف قلبي للحظات قبل أن أستدير، وعندما استدرت لم أنظر له لكني قلت وانا أنظر باتجاه البحر:
_ من قال هذا ؟
_ منذ فترة وأنت تتعمدين عدم النظر لي، لاحظت ذلك مرات عديدة، ألست معلمك الذي كنت تحبينه!
أجبت بسرعة:
_ وما زلت
_ هل هذا حب؟, كأنك أصبحت فجأة لا ترغبين برؤيتي.
_ أنا…….
_ أعلم، لا داعي للبحث عن كلمات، أنا أستاذك يا لوز، ألم تلحظي فارق العمر بيننا.
_ لا يهم.
_ وما الذي يهم ؟
_ المشاعر.
_ وهل تكفي من جانب واحد.
هنا فهمت ووضعت وجهي بالأرض ولم أجبه، فعاد يقول:
_ سألتك هل تكفي من جانب واحد ؟
نظرت له أخيراً والدموع تملأ عيني وقلت:
_ لا تكفي، لا تكفي أبدا
فأومأ برأسه وقال:
_ بيتكم دافئ، أحببته، أحببت أهلك، ولم أرك سوى لوز الصغيرة التي تنطلق بعجلتها وتصيح.
لم أرد على كلامه، لم يكن هناك ما يقال، لذلك استأذنت وتحركت بعيدا عنه، وسمعت خطواته تسير في الاتجاه المعاكس، حيث البحر، حيث انتهت أحلامه.